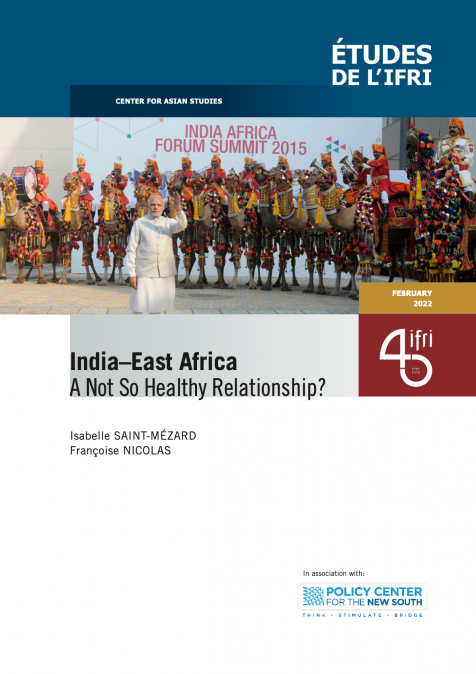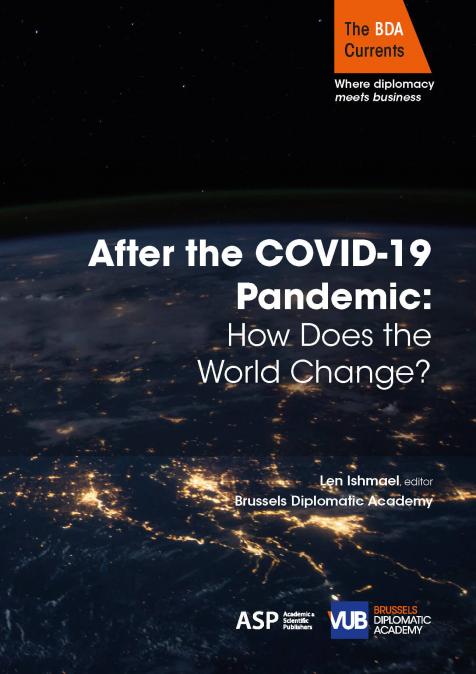Publications /
Opinion
لم تكن الأوبئة التي ساهمت، إلى جانب المجاعات، في تحديد الواقع الديموغرافي لمغرب ما قبل الاستعمار، بالشيء الجديد الطارئ على هذا البلد، الذي ارتبط استقرار نموه البشري بمحددات طبيعية، عجز لحدود تلك الفترة في التحكم فيها. فالوباء ضارب في القدم، وساق في طريقه إلى الحتف جماعات وأفراد من شعوب وأمم مختلفة، اختلفت في تمثله والتعامل معه، بين اعتباره قضاء وقدرا أو عقابا إلاهيا. ولما كان الفشل مصير العديد من محاولات درئه أو التصدي له أو الشفاء منه، فقد كان طبيعيا أن يتم استبطان ثقافة سلبية في التعامل معه، مما جعله قادرا على اختراق مجالات جغرافية واسعة، متحركا في ركاب المتنقل من بني البشر الذي ينقل معه العدوى. هكذا أخذ وباء الطاعون طريقه من الشرق عبر البر حينا وعبر البحر أحيانا أخرى، متسللا بين قوافل التجار تارة وبين ركب الحجيج تارة أخرى، قبل أن ينتشر بين مختلف جهات المغرب عبر آليات مختلفة، متسببا في هدر ديموغرافي مهول في كثير من الأحيان. نفس السيناريو تكرر مع وباء الكوليرا الذي عُرف عند المغاربة بالريح الصفراء أو بوكليب، والذي شكلت بلاد البنغال ودلتا الغانج بيئته الحاضنة بامتياز، قبل أن ينتقل منها إلى مختلف جهات العالم، ويصل إلى المغرب عبر تجار أوروبا أو حجاج المشرق، محدثا نزيفا سكانيا فظيعا.
الحجر الصحي في مواجهة الطاعون القاتل
شكلت نهاية القرن الثامن عشر بداية مجهود وقائي للتصدي لوباء الطاعون الوافد من الإيالة الجزائرية، فقد سبق للسلطان سيدي محمد بن عبد الله أن أقام نطاقا عسكريا في الحدود الشرقية، لوقاية المغرب من الوباء المتفشي في الجزائر. وابتداء من سنة 1792 شرعت الهيئة القنصلية المعتمدة بطنجة في اتخاذ إجراءات صحية وقائية، توجت سنة 1793 بانتزاع موافقة السلطان مولاي سليمان على فرض حجر صحي ضد الجزائر، ولو بشكل ظرفي. ومع سنة 1797 حصلت هذه الهيئة من نفس السلطان على ظهير خاص ينص على فرض الحجر الصحي على السفن القادمة من وهران وشل جميع المواصلات القارية في الحدود الشرقية. لكن هل هذا السلوك الاحترازي كان كفيلا بإغلاق الواجهة الشرقية للمغرب برا وبحرا في وجه وباء الطاعون الذي ظل يفتك بجيرانه في الشرق، وبالتالي الحد من دماره الديموغرافي؟
لم يتأخر الجواب كثيرا؛ ففي سنة 1799 انتشر الوباء بالمغرب. يقول محمد الضعيف الرباطي في هذا الشأن " وفي العاشر من رمضان 1213 (14 فبراير 1799) خرج مولاي الطيب من فاس الجديد بعد أن أتى من مكناس عاملا على تادلا والشاوية وخليفته أحمد بن عبد المالك الدريبكي. وكان الوباء بفاس الجديد وقصبة اشراكة وفي أولاد جامع. وكثر الموت في الناس وكذلك اشراكة". شكلت الظروف المحلية بنية استقبال مناسبة لتسريع حركية العدوى. فمن جهة تزامن مع فترة قحط وجفاف واجتياح للجراد، ومن جهة ثانية عمق العنصر البشري أثر هذه المعطيات الطبيعية، من خلال الحرْكة في المجال لإخضاع القبائل المتمردة. اتسم هذا الوباء بقوة تدميرية اختلفت المصادر في تقديرها، فإن كانت الروايات الأجنبية قد قدمت أرقاما مخيفة، فإن المصادر المغربية أيضا لم تهون من فداحة الخسائر، إذ يذهب صاحب "الابتسام" إلى أن نتائج الوباء الذي وصفه ب"الطاعون الكبير" كانت أكثر من كارثية. إذ يقول" كان يموت بفاس في كل يوم الألفان ونصف".
لم يكد ينفرط العقد الثاني من القرن التاسع عشر حتى أطل الوباء برأسه من جديد على المغرب، أي بعد أقل من عشرين سنة على الوباء السابق، مما خلف هدرا ديموغرافيا، قُدر في مدينة طنجة مثلا بخُمس ساكنة المدينة، التي صارت بيئتها حاضنة لشروط إعادة ظهور الوباء، خاصة ما أشار إليه القنصل الفرنسي بطنجة سوردو من أن الجثث المتراكمة في الحفر عند أبواب المدينة بفعل المجاعة، وكذا تهافت الجياع على الاقتيات بجثث الدواب التي تركت ملقاة على قارعة الطريق، أدت إلى خلق وضع متعفن ساعد على ظهور الوباء من جديد.
بوكليب الزاحف غربا يُجهز على ساكنة المغرب
تحدث العربي المشرفي عن دخول وباء الكوليرا إلى المغرب بالقول:" دخل الوباء المسمى عند المغاربة ببواكويبيس وبعضهم يسمونه ببوزريوطة، وعند أهل تلمسان بوقليب وبعضهم يسمونه مرض النفطة وبعضهم يسمونه الريح الحمراء(...) لأن الإنسان أكثر ما يطعن في جوفه، ومن حينه لا يحب زوال الماء من فيه، يشرب ويتقيأ إلى أن تخرج روحه وبعض الناس بمجرد الطعنة يسقط ميتا، وعلامة من مرض به برودة جسمه وغليان فؤاده دليله كثرة شربه".
تؤشر هذه المعطيات التي تقدمها المصادر على قوة تدميرية لوباء الكوليرا، لا تقل عما يخلفه الطاعون من ضحايا. وقد ظهر هذا الوباء أول مرة بالمغرب سنة 1834 ليتجدد مع تكرار موجاته العالمية التي اكتسحت جهات مختلفة من المعمور خمس مرات خلال القرن التاسع عشر.
عادت الكوليرا إلى المغرب محمولة في ركاب الموجة العالمية الثالثة للوباء، فضربته في مناسبتين قريبتين في الزمن: الأولى، وكانت أقوى وأعنف، عبرت الحدود الشرقية من الجزائر عشرين سنة بالضبط بعد الموجة الأولى، ذلك أنها حصدت أولى ضحاياها بالعاصمة فاس في نونبر 1854. وكان فتكها قويا بهذه المدينة؛ إذ تحدثت المصادر عن 300 إلى 400 ضحية في اليوم الواحد.
واستمرت الموجات العالمية إلى حدود الخامسة في زرع الكوليرا عبر المعمور محدثة هدرا ديموغرافيا متواليا. ولعل ما عمق مأساة المغاربة مع الوباء الوافد من الشرق، أكان طاعونا أو كوليرا، إضافة إلى البؤس والجوع وغياب وسائل ومرافق الوقاية أو العلاج، هو تزامنه أو تعاقبه مع أوبئة أخرى مثل الجدري أو التيفوئيد، الذي قضى بدوره على آلاف المغاربة ولم ينج من شره حتى علية القوم، حيث حصد في طريقه سنة 1879 الصدر الأعظم موسى بن أحمد، والد الحاجب والصدر الشهير أبا حماد.
د. الطيب بياض، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء، تخصص التاريخ المعاصر والراهن.
- خبير تقييم لدى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST
- عضو الهيئة العلمية لمعهد إدريس بنزكري لحقوق الانسان بالرباط، ومكلف بالنشر داخل نفس الهيئة.
- من مؤلفاته: المخزن والضريبة والاستعمار (الدار البيضاء ،2011)، رحالة مغاربة في أوروبا (الدار البيضاء ،2016)، الصحافة والتاريخ (الرباط، 2019)، أحداث 3 مارس 1973 بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة، حوار مع امبارك بودرقة (الدار البيضاء، 2020).